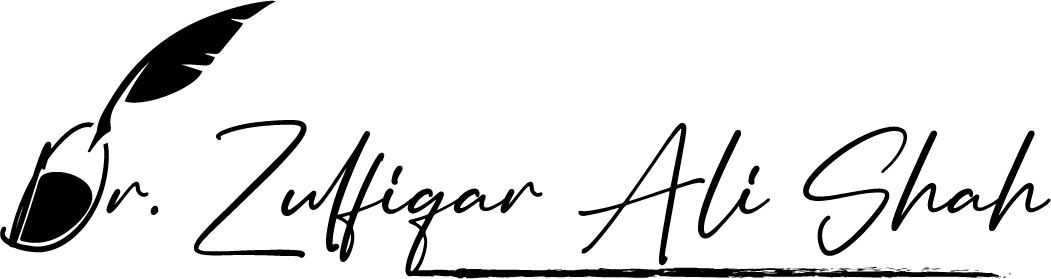التَّشْبِيهِيَّة والمقولات التعريفية

أربكت العلمانيةُ والماديةُ الفلسفيةُ واللاأدرية والإلحادُ الصارخ
المشهدَ الديني في القرن الحادي والعشرين، حتى إن المؤمنين الورعين
بالأديان صاروا أقلية. وهكذا فإن مستقبل الإيمان الغربي مظلم في ظل
خضوع الأمم للعلمنة المتواصلة. وهذا الموت للإيمان والإله ما هو إلا
تتويج لقرون طويلة من الخطاب حول مفهوم "الإله المتعالي" في الديانات
بوجه عام وفي اليهودية والمسيحية بوجه خاص
على مدى قرون عدة، ذهب فلاسفة ومثقفون وعلماءُ إلى أن مفهوم
الإيمان بالله يقوم على تصوُّر تشبيهي وبدائي ومربك ومعقَّد للغاية،
وذهبوا أيضاً إلى أن الإله المتعالي وشرائعه صارت لا تناسب الإنسان
ولا بيئته. واعتبروا أن الدعوة إلى "موت الإله" ضرورة لتحرير الإنسان
من القيود التي يفرضها عليه الدينُ وما يُطْلَق عليها تفسيرات الدين
للإنسان وللكون، والتي تُفْرَضُ على ما ينتجه الإنسانُ في العلم والثقافة
باسم الله. وهذه الرؤية تنظر للبشر على أنهم خالقون مستقلون ولا
تحدُّهم حدودٌ في خلق ثقافتهم ومصيرهم. ويؤكد هذه الرؤيةَ القول بأن
الإله نشأ في الوعي البدائي من خلال إسقاط مخاوف الإنسان وتطلعاته
على الكون، الأمر الذي أدّى – حسب هذا القول – إلى قيام الإنسان
بتشكيل إله أو آلهة لحمايته. وبالرغم من جاذبية هذه الرؤية لبساطتها،
نجد أنها تفشل في أن تضع في اعتبارها أن الإيمان بالله يزيد بشكل كبير
مع نمو معرفة الإنسان وذكائه، منذ الثقافات البدائية حتى الثقافات
المتطورة للغاية، وبذلك يكون الدين عبارة عن تدريب فكري، على
عكس الزعم بغير ذلك. ومع ذلك، يتم الترويج على نطاق واسع للعلم
والفلسفة على أساس أنهما تمكَّنا من القضاء على الحاجة إلى الله في الثقافة
والأنشطة البشرية. بمعنى آخر، في العصر الحالي، الله المعبود بوصفه
خالق الكون لم يعد مقبولا الآن على أنه خالق الإنسان وخالق الكون
الذي يعيش فيه الإنسان. وبدلا من ذلك، يُقال لنا إن الإنسان هو الذي
خلق الله على صورته
وليستْ نظريات أو مزاعم الإسقاط المتعلقة بالأصول البشرية
للمفاهيم الخاصة بالله وليدةَ العصر الحديث، بل يمكننا أن نُرجِعَها إلى
570 قبل الميلاد(، أي - الفيلسوف والشاعر اليوناني زينوفانيس ) 470
قُرابة ستمائة عام قبل ميلاد المسيح. كما أن هناك زعماً يرجع في الزمن
لقرون عدة مفاده أن الأديان والآلهة تنبع من رغبات الإنسان ومحاولاته
فذهب بيكون إلى أن الإنسان يضفي الصفة البشرية على كلِّ شيء غيره.
وطالب العلمُ والمذهبُ التجريبي بتخليص عمليات الفكر البشري
من التشبيه والتجسيد. ويُفَ التنوُّعُ المتفاوت في القوى الطبيعية كثرةَ الآلهة عند الشعوب البدائية،
فهذه الآلهة لها سمات بشرية بطبيعتها لأنها ناتجة عن أفكار وظروف
بشرية. ولذلك تتغير طبيعة الآلهة وصفاتها وملامحها بتغير أنماط
التفكير البشري وتغير الثقافات البشرية، ونسبت الشعوبُ البدائية
صفات بدائية لآلهتها من قبيل الأجسام المادية والصفات الجسدية
والسمات الإنسانية الفظّة. وأمّا الجماعات البشرية المتعلمة والأكثر
تطوراً فوصفت الآلهة بأشكال ومقولات أكثر تطوراً من قِبل المحبة
والشفقة والوجود الروحي والمقولات المتعالية. فتصوُّرُ إلهٍ أو آلهةٍ في
مجتمع ما يعكس ثقافة المجتمع وتطوُّرِه.
1711- ( رائدَ هذا - وفي العصر الحديث، كان ديفيد هيوم ) 1776
الاتجاهِ في التفكير، حيث قدَّم وصفاً أكثر تفصيلاً للطبيعة التشبيهية
للإله. ورأى أن الأفكار الإلهية لا تنبع من العقل، بل من جوانب الشك
الطبيعي في الحياة ومن الخوف من المستقبل. لقد نظر ديفيد هيوم إلى فكرة
الإله نظرة تطورية، ولذلك رفض النظرية القائلة بوجود الإله الواحد،
واعتبرَ الشكل الأول في الوجود من أشكال الدين قائماً على الوثنية أو
تعدد الآلهة. فمن وجهة نظر هيوم، يرجع أصل فكرة الإله إلى أن الإنسان
قام بتشخيص آماله ومخاوفه، ثم أسقط هذا التشخيص على الكون من
حوله، وبعد ذلك عَبَدَ الآلهةَ التي خلقها على صورته كإنسان.))) وهذا
الميل التشبيهي نحو تصوير كل القوى المجهولة على غرار الفئات البشرية
المألوفة هو المصدر التأسيسي لإيماننا بالإلهي. ويُعدّ تحليلُ هيوم مرشداً
وإطاراً مرجعيّاً للعديد من العلماء المحدثين المتخصصين في الفلسفة
الدينية وفي علم الاجتماع الذين يشاركونه فرضياته، ومنهم على سبيل
المثال: أوجست كونت، لودفيج فويرباخ، إدوارد تايلور، سيجموند
فرويد، توماس دي كونسي، روبرت براوننج، ماثيو أرنولد، جيرالد مانلي
هوبكنز، إيميلي برونتي، جان بول سارتر، موريس ميرلو بونتي، ألبير
كامي، أ. ج. أير، إ. د. كلمك. فعلى سبيل المثال، يذهب لودفيج فويرباخ
إلى أن "علم اللاهوت هو علم الإنسان ]الأنثروبولوجيا[… فموضوع
لا God وفي لغتنا الله theos الدين الذي نطلق عليه في اليونانية الإله
يعبر سوى عن جوهر الإنسان المؤلَّه، ولذلك فإن تاريخ الدين… ما هو
إلا تاريخ الإنسان."))) ويصّر فيورباخ على أن إله الإنسان هو الإنسان
والدين التقليدي ما هو إلا أفيون الشعوب ولا بدّ من تدميره حتى
تستيقظ الشعوب من سُبَا اِهت، وتلك هي مهمة العِلْم.
وفي القرن التاسع عشر الميلادي، دعا تشارلز داروين إلى نظريته في
الانتقاء الطبيعي، وأنكر النظرة التوحيدية لله على أنه الخالق والمُصوّر،
كما أنكر أن تكون الطبيعة تجلِّياً لهدف أو حكمة إلهية أو ديمومة.))) وتقوم
الميتافيزيقا التوراتية على تصوُّرٍ لإله محب للبشر خلق الإنسان خلقاً فريداً.
وأمّا رؤية العا المسيحية فتتمحور حول مفهوم الطبيعة البشرية الساقطة
والتدخل الإلهي من خلال التضحية، وما ينتج عن ذلك من فداء بصَلبِ
المسيح وقيامتهِ. وأمّا رؤيةُ العا لدى داروين وتفسيره للطبيعة على أنها
مستقلة وتوجّه نفسها بنفسها وفق نظرية النشوء والارتقاء، فقد أدّتْ إلى
تقويض رؤية العا المسيحية التقليدية بطريقة أكثر فاعلية من تقويض
الثورات العلمية التي قام بها كلٌ من كوبرنيكوس وجاليليو ونيوتن.
فتحدَّتْ نظريات داروين أسس الميتافيزيقا المسيحية ورجّتها رجة بالغة؛
إذ إن نظرية التطور عند داروين قضت على الحاجة إلى الإله باعتباره
مبدأ الخلق والراعي الوحيدَ لهذا الكون. فإذا كان الخلق قد تطوَّر تطوراً
طبيعيّاً من أصوله البدائية وكان يتطور باستمرار من خلال عملية الانتقاء
الطبيعي من دون أي تدخل إلهي خارجي، فمن المنطقي أن هذا الخلق لا
يحتاج إلى الله في وجوده وإعالته واستمراره
ومع أن المؤسسات الدينية عارضتْ نظريةَ التطور، فإن هذه النظرية
قد أصبحت المبدأ الرئيس في كل العلوم البارزة في القرن التاسع عشر
الميلادي. ولذلك، فإن العلماء التجريبيين، وعلماء الأنثروبولوجيا،
وفقهاء اللغة، وعلماء النفس، وعلماء الاجتماع، وعلماء الطبيعة في القرن
التاسع عشر الميلادي، لم يبحثوا في الله في السماء أو فيما وراء هذه الحدود
العملية، وإنما بحثوا في الله هنا على الأرض في عا هَملِم: في الطبيعة، أو في
الروح البشرية، أو في النفس، أو في المجتمع البشري، وكلهم بلا استثناء
تقريباً كانوا قادرين على أن يحددوا موضع الله، وأن يقولوا إنه موجود
في التجربة البشرية، أي في العمليات الذهنية التي يكتسبُ الإنسانُ من
خلالها الأفكارَ، ويتأثر وجوده بعواطف الإنسان وانفعالاته
وقام العديد من العلماء، بناء على افتراض فكرة نشأة الله في عا الإنسان، بإجراء بحوث كثيرة جداً تهدف إلى تحديد الأصل الدقيق
لفكرة الله والدين. ومع أن بعض الباحثين من أمثال الأب فيلهلم
شميت استخدموا نتائج بحوثهم في إثبات أن الدين البدائي في كل
البقاع بدأ بتصوُّر توحيدي في الأساس للإله، كان هؤلاء الباحثون
أقلية. وأما أغلبية علماء الأنثروبولوجيا وعلماء النفس وعلماء الاجتماع
وحتى بعض ما يُطلَق عليهم علماء اللاهوت، فزعموا أن أصول
الأديان تكمن في الأشكال البسيطة من الثقافات البدائية، في مذهب
حيوية الطبيعة، وفي الصنمية، وفي الطوطميّة، وادّعوا أن كل هذا
الأشياء والمعتقدات تطورت بدورها وتحولت إلى أشكال عليا من
الدين مثل الإيمان بتعدد الآلهة، والإيمان بإله واحد من دون إنكار
وجود آلهة أخرى، والتوحيد، وأخيراً التوحيد الأخلاقي في الديانات
الحديثة مثل اليهودية والمسيحية والإسلام، وهي ديانات تشمل القدر
الأعظم من المؤمنين في عصرنا الحالي
ومع أن هناك خلافات بين هؤلاء العلماء، فإنهم يتفقون، إلى حد
كبير، على نقطة واحدة، ألا وهي أن "الله" لا يتمتع بوجود موضوعي
مستقل، فوجوده يعتمد على احتياجات البشر وتطلعاتهم ومخاوفهم.
ويؤكد هؤلاء العلماء على أن كلمة "الله" ما هي إلا تجسيم أو تشخيص
أو إسقاط نفسي لقوى عا الإنسان الخارجي والداخلي والاجتماعي.
بمعنى آخر، الخطاب الدائر حول الله ما هو إلا خطاب الإنسان، أو
– حسبما يقول فويرباخ كما ذكرنا من قبل– "علم اللاهوت هو علم
الإنسان ]الأنثروبولوجيا[". وانتقل هذا التصور الجوهري للإله إلى
القرن العشرين، فنجد كلود ليفي شتراوس يقول بأن "الدين يكمن في
تشبيه الطبيعة على شكل البشر."))) » أَنْسَنَةِ قوانين الطبيعة"،
وعلى ضوء هذه الملاحظات، وبفحص تراث الأديان المعروفة
في العا ،َمل نجد أن التشبيه بالبشر مُتَضَمَّنٌ في كل الكتب المقدَّسة تقريباً
بدرجات متفاوتة. ويحاول علماء اللاهوت في كل هذه الأديان إزالة
التشبيه بالبشر من الكتب المقدسة، لكن بلا جدوى، بل يستعصي النص
المقدس، في أحيان كثيرة، على هذا النوع من المقاربات. وبما أنه من
المستحيل أن نناقش كل الأديان في هذا الكتاب الموجَز، سنقتصر في تناولنا
وملاحظاتنا على الأديان الساميَّةِ المتطورة الثلاثة التي تفترض أن أصولها
ترجع إلى الديانة الإبراهيمية: ألا وهي اليهودية والمسيحية والإسلام.
ففي الكتاب المقدس العبري أو العهد القديم، يتم تصوير الله على أنه
يتصف بصفات بشرية، سواء أكانت هذه الصفات عقلية أو جسدية، بما
يتناسب مع عرضه الماثل في "عمل الإنسان على صورتنا كشبهنا" )سِفر
26 (. وفي العهد الجديد، يتخذ الله شكلاً بشريّاً تاماً، فهو : التكوين: 1
تجسُّدٌ مقدَّسٌ في المسيح. وبالرغم من الجهود الجماعية الكثيرة التي قام
بها بعض العلماء اليهود وآباء الكنيسة )كما ستناول ذلك في فصول لاحقة
من هذا الكتاب( لإيقاف ذلك ونفيه، ظلَّ مفهوم الإله الذي يشبه البشر
جسديّاً قائماً في الديانتين معاً. والقرآن هو الكتاب المقدَّس الوحيد الذي
اجتنب هذا الاتجاه على الدوام وبشكل متسق، وصانَ الإلهَ من المقولات
والتصورات الجسدية والتشبيهية الفجة، ولكنَّ هناك خلافاً مزمناً بين
بعض الفِرق الإسلامية، مع أن هذا الخلاف ليس بفجاجة الخلاف الواقع
في اليهودية والمسيحية
وعلى الجانب الآخر، قام العديد من الباحثين والفلاسفة والعلماء
في العصر الحديث بتفنيد هذه الفكرة عن الدين باعتباره فهماً تشبيهيّاً لله
بالبشر. فبالإضافة إلى التطورات العلمية أو الميتافيزيقا العلمية والتفسير
الآلي للطبيعة، يمكننا أن نُرجِعَ جُزئيّاً هذا النفور من الدين الذي ذكرناه
من قبل إلى الطبيعة التجسيدية البشرية المبالغ فيها للأفكار التوحيدية
عن الله، خاصة في اليهودية وفي المسيحية. فالإنسان العلماني لا يحتاج
إلى إله متجسد يُشبهِ البشرَ ومحدودِ الإمكانات، ويريد هذا الإنسان
العلماني أن يتوصَّل إلى حلوله في الدنيا. فهو سعيد بأنه يعيش من دون
مِثل هذا الإله المحدود. ومع ذلك، أو لهذا السبب، ينتاب الإنسان في
العصر الحديث إحساس كبير بالاغتراب والعزلة والذاتية والنسبية
والعَدَمية. ويزداد هذا الشعور، وبشكل يُنذر بمزيد من السوء، مع
إدراكنا بأنه "إذا لم يكن الله موجوداً، فكل شيء مُبَاحٌ،"))) على حد قول
دوستويفسكي. وبوجه عام، فإن القيم الدينية لا تُلْزِمُ أحداً في الوقت
الحالي، والقيم الأخلاقية ليست مطلقة، وإنما هي نسبية إلى حد ما. فهذه
القيم تتلاشى بسرعة غير مسبوقة، على الأقل في الولايات المتحدة وفي
أوروبا، في حين أن القيم الأسرية والعائلية تتناقص في معظم أنحاء
في التاسع من » سي إن إن « العا المتقدِّم. فقد كشف استطلاع أجرته قناة
مارس عام 2009 أن أمريكا "تتضاءل نسبة المسيحية فيها."))) بالإضافة
إلى أن التدين والأخلاق في أمريكا المعاصرة أو أوروبا المعاصرة يختلفان
اختلافاً جوهريّاً عن التدين والأخلاق منذ عشرين سنة على سبيل المثال.
إن العديد من المعتقدات المسيحية، مثل الثالوث المقدس وتجسُّد المسيح
والخطيئة الأصلية، وكذلك القيم الأخلاقية مثل العفة الجنسية والحفاظ
على الحياة وكرامة الأسرة، تلقى تهاوناً في الكثير من الأحيان، أو تف بطريقة مختلفة تمام الاختلاف عن أصلها. والفكرة الحديثة عن الله ليست
باعثة على الرهبة، كما كانت في القرون الماضية، فالإنسان المعاصر نأى
بنفسه عن الله المتعالي، كما يظهر في التوحيد. ومازال الناس الذين يخشون
الله موجودين بالطبع، ولكن أغلبية البشر تتحقق فيهم الصورة التي
يصوّرها القرآن عندما يقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون
سورة الحشر: الآية 19
إن ما تناولناه من قبل يتضمن توجيه مُهتتين أساسيتين للفهم
التوحيدي لله. فأمّا التهمة الأولى فهي "تشبيه الله بالبشر". وهذه التهمة
لا تعني الإنكار التام لوجود الله، وإنما تعني أن أي وصف مادي لله،
كما يزعم المدافعون عن هذه التهمة ضد الدين، يرتبط ارتباطاً شرطيّاً
بفهم الإنسان لطبيعته والأثر المترتب على هذا الفهم. وأولئك الذين
اتهموا الأديان بهذه التهمة، منذ عهد زينوفانيس حتى الآن، يقولون
بأن الله يتعالى على هذا العا المادي ويختلف اختلافاً تاماً عن البشر؛
ولذلك فإن أي وصف لله يقوم على الطبيعة البشرية، أيّاً كانت عظمة
الصفات التي يتم وصفه بها، سيشوِّه كمالَ الله وسيكون أسوأ من عدم
وصفه من الأصل.
وأمّا التهمة الثانية فهي تهمة "الابتداع"، ويزعم المدافعون عن هذه
التهمة أن الله وهمٌ وليس له وجود، فهو يعتمد وجوديّاً على البشر الذين
يبتدعونه من خلال الإسقاط الكوني لطبيعتهم وسماتهم وصفاتهم عليه.
ويُبدي ستيوارت جَثْرِي ملاحظة مفادها أن من يقولون إن الدين تشبيه
بالبشر يقصدون أن الدين ينسب صفات بشرية للآلهة، أو أن الدين
عندما يزعم وجود آلهة، فإنه ينسب صفات بشرية للطبيعة. فالدين،
بالمعنى الأول، يجعل الآلهة يشبهون البشر بمنحهم القدرة على السلوك
الرمزي. وأمّا الدين، في الحالة الثانية، فيجعل الطبيعة صورة من البشر،
وذلك من خلال تصور الآلهة في الطبيعة. وينبغي علينا أن نعرِّف بعض
المفاهيم الأساسية المرتبطة بذلك، مثل تشبيه الله بالبشر، والتعالي، حتى
نفهم عمق هذه التهمة وحقيقتها
تشبيه الله بالبشر
يُشتق، في اللغة anthropomorphism " إن مصطلح "التشبيهية
إنسان( والكلمة اليونانية ( Anthropos الإنجليزية، من الكلمة اليونانية
شكل(. وهو مصطلح حديث نسبيّاً تطور في القرن الثامن ( morphe
عشر الميلادي. ويمكننا أن نعرِّف التشبيهية تعريفاً عاماً بأنها مَيْلٌ راسخٌ
إلى إسقاط صفات بشرية على الظواهر الطبيعية، سواء أكان ذلك بشكل
واعٍ أم غير واعٍ، أو وصف الكائنات الروحية غير المادية بصورة جسدية،
وبصورة بشرية، خاصةً. ويدل المصطلح، بالمعنى الديني، على اتجاه
بشري عام نحو الإحساس بالله والتعبير عنه والتضرع إليه بأشكال بشرية
أو تصورات ومقولات بشرية. ويمكن أن يعني التشبيه بالبشر أن ننسب
لله شكلاً بشريّاً أو عضواً بشريّاً.
ففي سعيهم لتضييق نطاق الله والدين، ومن ثمّ الحد من نفوذ
الكنيسة وتأويلاتها للإنسان وبيئته، روَّج العلماء والباحثون التجريبيون
لتهمة التصوير البصري المبالَغ فيه أو التشبيه الجسدي بالإنسان بأن
وسَّعوا نطاقها لتشمل كل جوانب الله التي يُعتَقَد بأنها شبيهة بالإنسان.
كما أكدوا تهمة التشبيه بالإنسان تأكيداً كبيراً لدرجة أنها صارت تُلْصَقُ
بأي سمة أو صفة إلهية، مهما كانت أخلاقية أو روحانية، فإذا ارتبطت
بالمجال البشري تُسمَّى تشبيهاً بالإنسان وحسب، وفقد هذا الاتهام معناه
المعقول لأنه تجاوز حدوده، كما أنه جُرِّدَ من سياقه الحقيقي وصار مجرد
مصطلح لومٍ أو وسيلةً للتعبير عن النفور
Related Articles
The emergence of Islam in the 7th century CE with a distinct, democratically oriented, consultative governmental structure
Dr. Zulfiqar Ali Shah, Even though the central pivot of all New Testament writings is Jesus Christ and crucial information...
Gaza City, home to over 2.2 million residents, has become a ghostly emblem of devastation and violence
Gaza City, a sprawling city of over 2.2 million people is now a spectral vestige of horrors
The Holy Bible, a sacred text revered by Jews and Christians alike, has undergone centuries of acceptance as the verbatim Word of God
Tamar, the only daughter of King David was raped by her half-brother. King David was at a loss to protect or give her much-needed justice. This is a biblical tale of complex turns and twists and leaves many questions unanswered.
There is no conflict between reason and revelation in Islam.
The Bible is considered holy by many and X-rated by others. It is a mixture of facts and fiction, some of them quite sexually violent and promiscuous. The irony is that these hedonistic passages are presented as the word of God verbatim with serious moral implications.